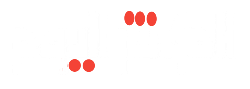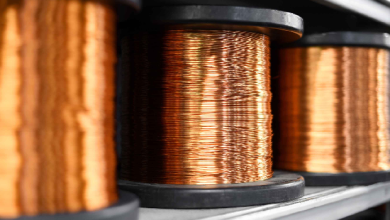دراسة: 6 تحديات رئيسية تعوق تحقيق العدالة المائية في مصر

انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر إلى 585 مترا مكعبا سنويًا، وهو رقم يقل كثيرًا عن خط الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب للفرد، ومع توقعات زيادة عدد السكان إلى 120.8 مليون نسمة بحلول 2030، ستتضاعف الضغوط على الموارد المائية المحدودة.
ورصدت دراسة حديثة حصلت “البورصة” على نسخة منها، وجود 6 تحديات رئيسية تعوق تحقيق العدالة المائية، وهي عدم مساواة توزيع المياه، وضعف الإدارة المجتمعية، وتقادم البنية التحتية للري، وبطء تبني التقنيات الحديثة، وتفتت الحوكمة، ومحدودية التمويل اللازم لتطوير نظم الري.
الورقة البحثية أعدتها نورا عبد الوهاب، خبيرة الاقتصاد والتنوع الاجتماعي بالمعهد الدولي لإدارة المياه، وفيروز الدباغ، الباحثة في العلوم السياسية بالمعهد الدولي لإدارة المياه، بعنوان “الانتقال المائي العادل في مصر: المجتمع المدني والإدارة العادلة للري”.
تحديات متعددة الأبعاد
كشفت الدراسة أن قطاع الزراعة وحده يستهلك 76% من إجمالي الموارد المائية، ومع ذلك تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.6% خلال 2023، كما تراجعت نسبة فرص العمل الزراعية إلى 18% فقط.
وتبلغ نسبة الفقر في الريف 29.7%، حسب الدراسة، بينما تستحوذ خدمة الدين العام على 47.4% من الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، ما حدّ من قدرة الدولة على الاستثمار في تطوير البنية التحتية المائية.
وسلطت الورقة البحثية الضوء على تحديات رئيسية تعوق تحقيق العدالة المائية في مصر، فهناك تفاوت كبير في وصول المياه بين المناطق والمزارعين، خاصة بين الأراضي القديمة التي تعتمد على مياه النيل والأراضي المستصلحة حديثًا التي تعتمد على المياه الجوفية.
اقرأ أيضا: “الإسكان” تتخذ إجراءات لترشيد الطاقة والمياه في المدن الجديدة
كما أن شبكات الري تعاني التآكل وضعف الصيانة، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه وارتفاع ملوحة التربة، حسب الدراسة، إضافة إلى أن التقنيات الحديثة مثل الري بالتنقيط والطاقة الشمسية لا تزال محدودة الانتشار، وغالبًا ما تقتصر على المزارعين الأكثر ثراءً أو من يمتلكون المهارات الرقمية.
كشفت الباحثتان أن التنسيق بين الجهات الحكومية وروابط مستخدمي المياه يعاني ضعفًا، كما أن مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار لا تزال استشارية أكثر منها تنفيذية، ناهيك بأن صغار المزارعين يعانون صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتحديث نظم الري أو تبني تقنيات جديدة، في ظل ارتفاع المخاطر المناخية والاقتصادية.
الباحثتان أشارتا إلى أن ملوحة المياه الجوفية في الدلتا في تزايد دائم، بسبب تسرب مياه البحر، بينما تؤدي موجات الحرارة إلى زيادة معدلات البخر، وتتعرض بعض المناطق لنقص المياه بسبب تراجع الأمطار.
سياق السياسات والإطار القانوني
حسب الدراسة، تستند إدارة المياه في مصر إلى مجموعة من السياسات والإستراتيجيات الوطنية، مثل “رؤية مصر 2030″ ، و”الخطة القومية للموارد المائية 2017–2037″، و”استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030”.
كما صدرت قوانين مهمة مثل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الذي ينظم عمل روابط مستخدمي المياه ويهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولا تزال فجوات التنفيذ تحيط بالقطاع، حسب الدراسة، خاصة فيما يتعلق بتمكين المجتمع المدني وروابط المستخدمين من المشاركة الفعلية في إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل الكافي لتحديث البنية التحتية وتبني الابتكارات.
خارطة طريق للانتقال المائي العادل
اقترحت الورقة البحثية سياسات عملية لتحقيق الانتقال المائي العادل، موزعة على 3 مراحل زمنية. فعلى المدى القصير (خلال 10 أشهر) يتم تنفيذ برنامج تجريبي لتدريب روابط مستخدمي المياه على إدارة وتشغيل نظم الري وحل النزاعات واستخدام التقنيات الحديثة، مع التركيز على إشراك النساء والشباب، إضافة إلى تطوير مواد تعليمية مثل الفيديوهات والدراسات الحقلية لنشر أفضل الممارسات الزراعية، وتقديم نموذج تمويل مشترك لتغطية تكاليف التشغيل، مع تخصيص تمويل أساسي من وزارة الموارد المائية والري.
أما على المدى المتوسط (6 أشهر إلى سنتين)، أشارت الباحثتان إلى إنشاء صندوق تمويل مختلط للابتكارات المائية الذكية مناخيًا، بمشاركة وزارات التخطيط والري والزراعة والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات، لتقديم قروض منخفضة الفائدة للمزارعين المتبنين تقنيات الري الذكية، مع تنفيذ المشروع التجريبي في 4 محافظات تمثل ظروفًا مناخية وزراعية متنوعة (الدلتا، الصعيد، الأراضي المستصلحة حديثًا)، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات لتقييم المخاطر وتسهيل الوصول للتمويل وتفعيل آلية وطنية لتخفيف مخاطر التغير المناخي بالتعاون مع مؤسسات بحثية.
بينما المدى الطويل (سنة واحدة) يشمل، حسب الدراسة، إعادة هيكلة حوكمة الموارد المائية عبر مشاورات رسمية بين الجهات الحكومية وروابط المستخدمين وتأسيس لجان مشتركة على مستوى المحافظات لإدارة وتوزيع المياه، مع إنشاء لجنة استشارية وطنية لمستخدمي المياه ضمن المجلس الوزاري المشترك للمياه، لضمان إيصال صوت المزارعين في صنع السياسات وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.
نتائج مرجوة
بيّنت الباحثتان أن هدف تلك السياسات تحقيق توزيع عادل وفعال للمياه، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، ورفع كفاءة استخدام المياه عبر التدريب والتقنيات الحديثة والتمويل المبتكر، كما تسعى إلى تعزيز قدرة الريف المصري على التكيف مع التغير المناخي ودعم التنمية العادلة وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة تحديات ندرة المياه.
وكان البنك الدولي أصدر في وقت سابق دراسة بعنوان “ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أكد فيها أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهدان خسائر اقتصادية بسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، تقدر بـ6 – 14% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050، بينما لا تساوي إنتاجية المياه بالمنطقة إلا نحو نصف المتوسط العالمي.